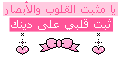|
من فقه الدعاء
يقول سيدنا عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: "أنا لا أحمل همَّ الإجابة، وإنما أحمل همَّّ الدعاء، فإذا أُلهمت الدعاء كانت الإجابة معه".
وهذا فهم عميق أصيل ، فليس كل دعاء مجابًا، فمن الناس من يدعو على الآخرين طالبًا إنزال الأذى بهم ؛ لأنهم ينافسونه في تجارة ، أو لأن رزقهم أوسع منه ، وكل دعاء من هذا القبيل ، مردود على صاحبه لأنه باطل وعدوان على الآخرين.
والدعاء مخ العبادة ، وقمة الإيمان ، وسرّ المناجاة بين العبد وربه ، والدعاء سهم من سهام الله ، ودعاء السحر سهام القدر، فإذا انطلق من قلوب ناظرة إلى ربها ، راغبة فيما عنده ، لم يكن لها دون عرش الله مكان.
جلس عمر بن الخطاب يومًا على كومة من الرمل ، بعد أن أجهده السعي والطواف على الرعية ، والنظر في مصالح المسلمين ، ثم اتجه إلى الله وقال: "اللهم قد كبرت سني ، ووهنت قوتي ، وفشت رعيتي ، فاقبضني إليك غير مضيع ولا مفتون ، واكتب لي الشهادة في سبيلك ، والموت في بلد رسولك".
انظر إلى هذا الدعاء ، أي طلب من الدنيا طلبه عمر، وأي شهوة من شهوات الدنيا في هذا الدعاء ، إنها الهمم العالية ، والنفوس الكبيرة ، لا تتعلق أبدًا بشيء من عرض هذه الحياة ، وصعد هذا الدعاء من قلب رجل يسوس الشرق والغرب ، ويخطب وده الجميع ، حتى قال فيه القائل:
يا من رأى عمرًا تكسوه بردته ** والزيت أدم له والكوخ مأواه
يهتز كسرى على كرسيه فرقًا ** من بأسه وملوك الروم تخشاه
ماذا يرجو عمر من الله في دعائه ؟ إنه يشكو إليه ضعف قوته ، وثقل الواجبات والأعباء ، ويدعو ربه أن يحفظه من الفتن ، والتقصير في حق الأمة ، ثم يتطلع إلى منزلة الشهادة في سبيله ، والموت في بلد رسوله ، فما أجمل هذه الغاية ، وما أعظم هذه العاطفة التي تمتلئ حبًا وحنينًا إلى رسول الله -  لم -: (أن يكون مثواه بجواره).
يقول معاذ بن جبل - رضي الله عنه -: "يا بن آدم أنت محتاج إلى نصيبك من الدنيا ، وأنت إلى نصيبك من الآخرة أحوج ، فإن بدأت بنصيبك من الآخرة ، مرّ بنصيبك من الدنيا فانتظمها انتظامًا ، وإن بدأت بنصيبك من الدنيا ، فائت نصيبك من الآخرة ، وأنت من الدنيا على خطر).
وروى الترمذي بسنده عن النبي - لم -: (أن يكون مثواه بجواره).
يقول معاذ بن جبل - رضي الله عنه -: "يا بن آدم أنت محتاج إلى نصيبك من الدنيا ، وأنت إلى نصيبك من الآخرة أحوج ، فإن بدأت بنصيبك من الآخرة ، مرّ بنصيبك من الدنيا فانتظمها انتظامًا ، وإن بدأت بنصيبك من الدنيا ، فائت نصيبك من الآخرة ، وأنت من الدنيا على خطر).
وروى الترمذي بسنده عن النبي -  لم -: أنه قال: ((من أصبح والآخرة أكبر همه جمع الله له شمله ، وجعل غناه في قلبه ، وأتته الدنيا وهي راغمة ، ومن أصبح والدنيا أكبر همه فرَّق الله عليه ضيعته ، وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كُتب له)).
وأخيرًا .. أرأيت كيف أُلهم عمر الدعاء وكانت الإجابة معه ، وصدق الله العظيم إذ يقول: (وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ) (186)" (البقرة:186). لم -: أنه قال: ((من أصبح والآخرة أكبر همه جمع الله له شمله ، وجعل غناه في قلبه ، وأتته الدنيا وهي راغمة ، ومن أصبح والدنيا أكبر همه فرَّق الله عليه ضيعته ، وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كُتب له)).
وأخيرًا .. أرأيت كيف أُلهم عمر الدعاء وكانت الإجابة معه ، وصدق الله العظيم إذ يقول: (وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ) (186)" (البقرة:186).
|